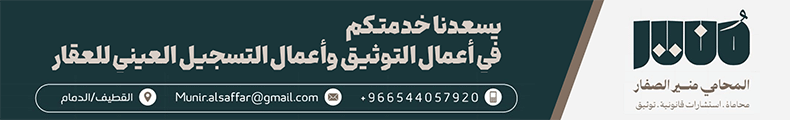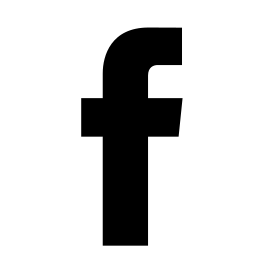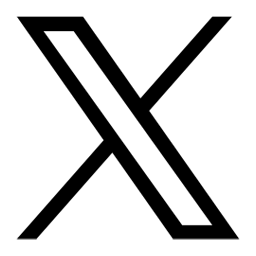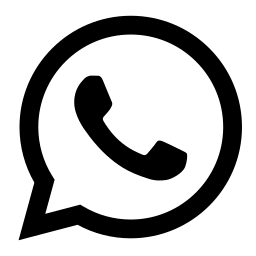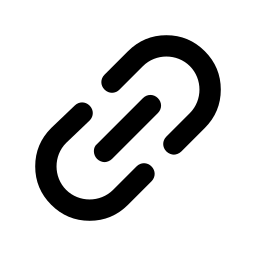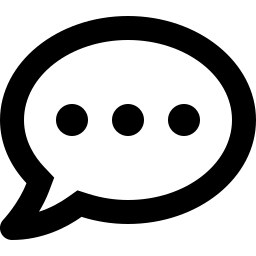الحسين عنوان للمحبة والسلام
حين نستحضر ثورة الإمام الحسين  ، فإننا لا نستدعي حادثةً تاريخيةً فحسب، بل نوقظ في ذاكرتنا نداءً خالدًا من أجل القيم والمبادئ التي انتفض لأجلها، سعيًا للإصلاح والتغيير في أمة جدّه المصطفى ﷺ. وهو القائل:
، فإننا لا نستدعي حادثةً تاريخيةً فحسب، بل نوقظ في ذاكرتنا نداءً خالدًا من أجل القيم والمبادئ التي انتفض لأجلها، سعيًا للإصلاح والتغيير في أمة جدّه المصطفى ﷺ. وهو القائل:
”إني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا، ولا ظالمًا ولا مفسدًا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله ﷺ، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق.“
إننا نعيش ذكرى عاشوراء كل عام، لا من باب البكاء والحزن فقط، ولا لنغرق في استحضار الماضي فحسب، ولا كما يدّعي البعض بأنها مناسبة لإثارة الحساسيات المذهبية؛ بل نحييها لنستلهم من نهضة الحسين روحًا وفكرًا وسلوكًا، انطلاقًا من فهمٍ حقيقيٍّ لهوية تلك الحركة العظيمة، القائمة على ركيزتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مواجهة واقعٍ كاد أن يطمس معالم الإسلام وقيمه، بفعل تسلّط نخبٍ فاسدةٍ على مراكز القرار، وتعمدها طمس الروح الإسلامية والإنسانية.
وما واقعة كربلاء إلا مرآةٌ صادقة لما بلغته الأمة آنذاك من انحدارٍ أخلاقيٍّ وسياسيٍّ، نتيجة سياساتٍ جائرةٍ متعاقبة، بعيدة عن مقاصد الإسلام وكرامة الإنسان. ولعل كلمات الإمام الحسين  تؤكد ذلك، حين قال:
تؤكد ذلك، حين قال:
”ألا ترون إلى الحق لا يُعمل به، وإلى الباطل لا يُتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما.“
إنّ قضية الإمام الحسين  هي قضيةٌ إنسانيةٌ بامتياز، لا تخص طائفةً ولا دينًا بعينه، بل تتجاوز الحدود، وتلامس وجدان كل من يؤمن بالحرية والكرامة. لم تكن انتفاضته تصفيةً لحساباتٍ تاريخية، ولا سعيًا إلى مُلكٍ زائل، بل كانت صرخة ضميرٍ نيّر، أراد بها أن يُعيد للأمة وجهها المشرق، ويضع حدًّا لانحدارها نحو التبعية والذل والانكسار.
هي قضيةٌ إنسانيةٌ بامتياز، لا تخص طائفةً ولا دينًا بعينه، بل تتجاوز الحدود، وتلامس وجدان كل من يؤمن بالحرية والكرامة. لم تكن انتفاضته تصفيةً لحساباتٍ تاريخية، ولا سعيًا إلى مُلكٍ زائل، بل كانت صرخة ضميرٍ نيّر، أراد بها أن يُعيد للأمة وجهها المشرق، ويضع حدًّا لانحدارها نحو التبعية والذل والانكسار.
وإلا، فكيف نفسّر وقوف وهب النصراني مدافعًا عنه حتى الشهادة؟ وكيف لا نستذكر جون الحبشي، ذلك العبد الأسود الذي اختار أن يُستشهد بين يدي الحسين، ليُكتب اسمه في سجلّ الخالدين؟ بل كيف لا نُصغي إلى صدى غاندي، حين قال:
”تعلّمت من الحسين كيف أكون مظلومًا فأنتصر“؟
الحسين لكل إنسان، مهما كان دينه أو لونه أو انتماؤه.
ومن هنا، فإنّ واجبنا اليوم، وسط هذا الزحام من الأزمات والضياع، أن نُعيد قراءة كربلاء لا بوصفها حدثًا عابرًا، بل بوصفها منارةً تهدينا نحو النور. علينا أن نُفعّل قيمها في واقعنا، ونستنطق رسالتها بما يُلامس جراحنا، ونتعامل مع عاشوراء كنبضٍ حيٍّ يعلّمنا كيف ننتصر على الخوف، ونقاوم الاستسلام، ونبني الإنسان.
لقد سلك الإمام الحسين، منذ خطوته الأولى، طريق السِّلم لا السلاح، والعدل لا الانتقام. كان مشروعه مشروع بناء لا هدم، تهذيب لا عنف، وعي لا تعصّب. ولذلك، فإن تجديد خطاب الحسين اليوم لا يعني إسقاط التراث، بل تحريره من القوالب الجامدة، وبثّ روحه في لغتنا، في خطابنا، في منابرنا.
إن خطباء المنبر الحسيني والمثقفين تقع على عاتقهم مسؤولية عظيمة في إيصال مفاهيم هذه النهضة، بلغةٍ تتماشى مع روح العصر، عصرٍ باتت فيه كربلاء تُذكر لا في الحسينيات فقط، بل في جامعات الغرب، وعلى ألسنة مفكرين مستشرقين ومسيحيين وهندوس، رأوا في الحسين بطلًا للحرية، ومعلّمًا للإنسانية. وهذا يستدعي منا أن نخاطب العالم بلغة يفهمها، لا بلغة تجترّ التاريخ، بل تصنعه من جديد.
إن الدعوة إلى تطوير الخطاب الحسيني وتوسيع آفاقه، ليست تقليلًا من شأنه، بل تجديد لرسالته، وتجذير لمكانته في قلوب الناس. فالحسين لم يأتِ ليكون رمزًا للحِداد فقط، بل ليكون نورًا للوعي، وبوصلةً نحو الإصلاح، ومحركًا للنهضة الفكرية والاجتماعية والدينية.
إن كربلاء لم تكن أرضًا لصراع عابر، بل مسرحًا ارتقى فيه الإنسان فوق كل انتماء. وهبٌ النصراني، وجون الحبشي، وزهير العثماني، وسائر الشهداء من شتّى الأصول والأديان، كتبوا بدمهم أن الحسين ليس لطائفة، بل للحقيقة حيث كانت.
فلنجعل من نهضة الحسين  منطلقًا لتجديد الوعي الإنساني، ودعوةً دائمة للمحبة والسلام، ونبذًا للكراهية والبغضاء.
منطلقًا لتجديد الوعي الإنساني، ودعوةً دائمة للمحبة والسلام، ونبذًا للكراهية والبغضاء.
ولنجعل من موسم عاشوراء عنوانًا لوحدتنا وعزّتنا.