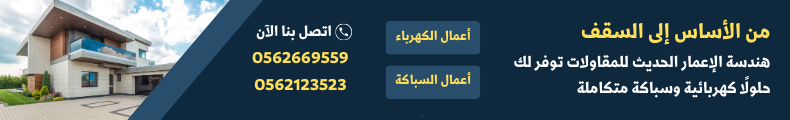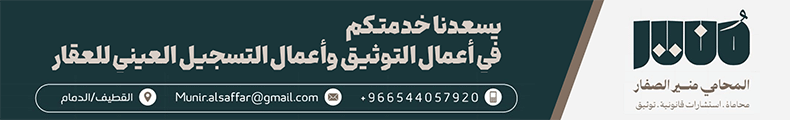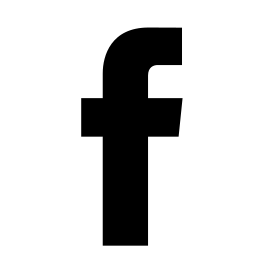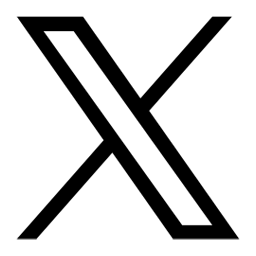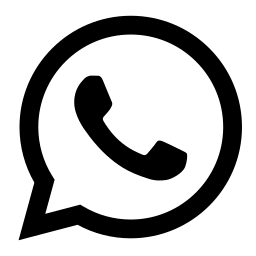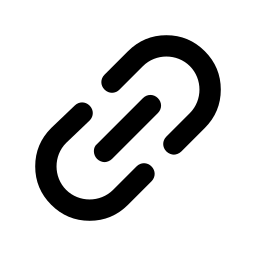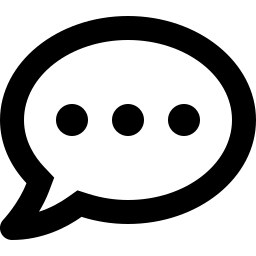باحث: التنمية المستدامة «حتمية».. ومشاركة المجتمع «ضرورة»

عرّف م. رياض بوحليقة، التنمية المستدامة، بأنها المحافظة على البيئة والاقتصاد والمجتمع عند توظيف الموارد المختلفة؛ لتنفيذ التنمية المطلوبة، دون المخاطرة بحصة الأجيال القادمة، بما يتطلب الجهد الكبير لتدوير مخلفات الموارد التي استخدمت.
جاء ذلك في محاضرته بعنوان ”الاستدامة الاجتماعية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة“، بتنظيم الجمعية السعودية لعلوم العمران، فرع الأحساء، بالتعاون مع فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية، وبالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، بدار نوارة الموسى.
وقال: إننا بعيدون عن هذا المفهوم، وإن ما يستخدم أكثر بكثير من حاجة الناس الفعلية، وهناك هدر، وتلوث، وإذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم آخر نفكر ”بمنهج عصري للتنمية“ يعني بالمحافظة على ”الاستدامة الاجتماعية“ والبنية الاقتصادية، ويعني استدامة كينونة الأشياء الأصلية والمحافظة عليها كما هي.
ومثّل لذلك ”بالنخيل“، فهناك عدد معين، ولكل نخلة عمر، وهناك تعداد سكاني متزايد، فلا بدّ من المحافظة على تزايد عدد النخيل، ليلبي حاجة الأجيال القادمة.
وبين أن ”الاستدامة الاجتماعية“ تتطلب المحافظة على أصالة المجتمع، بالحفاظ على موارده ومستجداته أيضًا ”استيعاب المستجدات“، مشيرًا إلى وجود منهج أفضل في السابق في الاستفادة من توظيف أمور كالكهرباء والشوارع، والآن صار لدينا ترف، فمنزل 50 مترًا كان يكفي الشخص، والآن لا يكفيه 500 متر.
وأضاف: يفترض بالاستدامة الاجتماعية أن تحافظ على كينونة المجتمع الاصلية، فتستفيد أو تتبنى خيارات للتنمية تلائم بشفافية المجتمع وعاداته حسب المعايير العالمية.
وذكر أن الناس لا تفكر فيها بالشكل المطلوب، فالمفترض الاعتماد على أنفسنا ومواردنا قدر الإمكان وتقليل الاستيراد.
وعدد بعض الخدمات في التنمية المفترض توفيرها ذاتيًا، كالغذاء المتكامل بجودة عالية، والرعاية الصحية الأولية، والتعليم الأساسي، إضافةً إلى التنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أهمية ”مراقبة الأداء“ لتحقيقها، ومنها توفير الخدمات الاجتماعية بالشكل الفائق، كالمرافق الدينية والمحلات ومراكز التسوق، وكذلك الزراعة التجميلية والمائية، وهي من المستجدات.
ولفت إلى الفرص غير المحدودة التي وفرتها الحكومة واللجان في تلك المجالات من منطلق رؤية 2030، وتستحق الوقوف عندها لتحقيق الخدمات المفترض توفرها.
وتابع: حاليًا نسعى لربط ”التنمية الاجتماعية“ بتحفيز وتسريع أهداف ”التنمية المستدامة“، وعند التحدث عن خطط التنمية يفترض الخروج بخطط من جهود أبناءنا، لا إسقاط خطط الآخرين في التنمية وأداءهم وإن كان ناجح لديهم.
وأشار إلى ما نفذته حكومة الإمارات في الاستفادة من التجربة الكندية الناجحة في التنمية والتي لا يزالون يعدلون عليها، لافتًا إلى مطالبة اللجان المحلية لتعديل تلك الخطة بما يتناسب مع المجتمع الإماراتي.
وأكمل" نحتاج إلى خطة تناسب وضعنا المحلي، وميزان لقياس الأداء للنواحي المختلفة للخدمات الاجتماعية، فمثلًا أهداف التنمية المستدامة كما تطرحها الأمم المتحدة، عناصر كل هدف تحتاج إلى مقياس معين لنرى مقدرتنا على تحقيقها، فقد لا نستطيع تحقيق هدف معين في مكان ما لعدم مناسبته للبيئة، أو لا تتوافر إمكاناته بالمجتمع أو ثقافته لا تسمح، فهذه من المعايير التي لابد من التفكير فيها.
وأضاف: قد لا نأخذ نفس العناصر للهدف بالضرورة، بل نأخذ المعيار فقط ونوظفه، أو نعدل عليه، ونستحدث أدوات تقييم لقياس أثر التنمية، منوهاً إلى أنه لا ينفع أن نقول لدينا تنمية وهذه هي الخطة بدون وجود معيار أو وسائل لتحديد أثرها، فقد يكون العنصر غير مناسب، أو أثره ضعيف أو سلبي فنلغيه، أو نستبدله بآخر لتحسين وضع المعيشة لدينا.
وأكد أهمية استدراك الحلول البديلة المناسبة للحاضر والأولويات، وإيجاد سبل لمشاركة الجهات المستفيدة فكثير من الأحيان تصرف أموال على أمور لا يحتاجها الناس فعلياً، أو يحتاجوها ولكن في مكان آخر، فلا بد من مشاركة المجتمع والقطاع الخاص والتعاون مع مؤسسات التدريب والتنمية الذاتية.
ولفت إلى أهمية وجود ”أدوات تقييم“ على مستوى الأفراد والمجتمع، وتحفيز أفراد المجتمع للمشاركة في المبادرات.
واستعرض صورًا للتاريخ الأحسائي، وكيف كان يحصل على حاجاته، ويوظف جميع موارده لخدمتها، مشيرًا إلى أهمية وضع معيار لقياس كيفية تحقيقه لذلك فنسبة الاستيراد لديهم لم تكن تذكر.
وتشير الصور إلى عائلة لديها منتج محلي يكفي حاجتها ويساهم في اعطاء السوق منتج يحتاجه المجتمع، وهناك المخايطة والحدادين والصاغة والأسواق الموزعة على المناطق، كسوق الخميس في الهفوف، والربعاء في المبرز.
واختتم بالتشديد على أهمية ربط النسيج العمراني بما ينسجم مع حاجاتنا المجتمعية المختلفة.
وشهدت المحاضرة عدة مداخلات، شملت السؤال عن الإنتاج المحلي، وفكرة استيراد المنتج، ومن يصنعه، فقال: هذا يتعارض مع مفهوم التنمية المستدامة الحقيقي، ولتحقيقها ينبغي أن نتوقف للتقييم، فالأحساء مثلا غنية بالموارد والأرض والناس، المشكلة في التفكير، الحكومات الآن تسعى لتقليل الوظائف، وتطلب مبادرات وريادات أعمال وهذا جيد، ولكننا بحاجة إلى أن نرى ما الأعمال التي تضيف للتنمية المستدامة، كما رأينا في المنتجات التحويلية للتمور في النخيل وهذا ممتاز.
وبسؤاله عن استيراد المباني الخضراء صديقة البيئة والاستدامة في العمارة، وعدم وجود معماريين ينتجون أفكار تناسب بيئتنا المحلية كالأحساء، ذكر: هناك عدة أخطاء كما ذكرت نحتاج أن نتوقف للتقييم، مع البترول احتاجت الحكومة لاستيراد مستشارين أكفاء ”مهندسين، وكفاءة“ فاستوردت الخبرة وثقافتهم مختلفة عنا، وأفضل ما لديهم لا يناسبنا، وكان يفترض أن يشارك أهل الخبرة المجتمع للخروج بشيء مختلف عن المعروف ببلادهم، والذي حصل أننا كملنا على نفس منوالهم فتغير النسيج العمراني.
وأضاف: صرنا مثلا من ناحية الموارد نستخدم الأسمنت مع أنه أكثر المواد التي تسبب انبعاث كربوني حراري وتلوث بيئي، والآن يفكر البعض في معالجة المسألة، كما صار هناك ابتكارات في استخدام المواد الأرضية الأقرب للطين، وتحتاج للتبني كمواد.
وتابع: الأكثر أهمية إعادة تقييم النسيج العمراني الذي تغير فهل يسعف حالتنا الاجتماعية الآن، عاداتنا وتقاليدنا، هل البنى الاجتماعية تشجع على صلة الرحم؟ الآن البيوت متباعدة، من قبل كان هناك ”صكيك“، ونستطيع الاستفادة من حالة الفريج والساباط والبرايح بالربط بين المساحات لتوظيف النسيج العمراني لتحقيق الاستدامة الاجتماعية.
وحول مناسبة الفريج للمدينة الحديثة من عدمه، قال: تطرح الحكومة الآن فرصًا متنامية، وسمعت بقرار عن النمط العمراني سينفذ بالأحساء، يختلف عن الذي بالرياض؛ للمحافظة على الهوية والتراث.
وأضاف: نحن لا يفترض أن نفكر كاستشاريين، الاستشاري يفرض رأيه على المجتمع والمفروض يشارك المجتمع في الحل الذي يتقدم به، يفترض كأهل خبرة أن نوظف المكان لخدمة حاجة المجتمع، نحن نقوم بتحويل مجتمعنا من اجتماعي إلى مجتمع أفراد، والأفراد قليل أن يعرفوا بعضهم.
وتابع: نقوم بعمل بيوت منعزلة عن بعضها، للخوف من أثر الحرائق، ولكن كان الفريج والبراحة والساباط يخدمنا، الأطفال عندنا الآن أين يلعبون، بالشارع، وما أكثر الحوادث، لكن قبل في الصكة لا توجد حوادث، كما أن الأشخاص الذين يمرون ويرون سلوكيات الأبناء أثناء اللعب كأنها مسرحية أمام أعينهم يمارسون دور المربي والتوجيه، الآن نخاف على الأبناء من السيارات وهناك حالات خطف ومشاكل أخرى فحرمناهم من العناية التربوية الطبيعية، التي تزرع فيهم عاداتنا وتراثنا وتقاليدنا.
وبسؤاله عن استحداث أنظمة وطرق معمارية تحقق الاستدامة، وحاجة البيوت مثلا إلى استحداث طرق لتبريدها، قال: نتحدث عن توظيف النسيج العمراني لخدمة المجتمع، فلعب الأطفال بالتراب مع الاستماع لوجهة نظر المجتمع يمكن توظيفه كمعماريين بالطرق الأمثل.
وأكمل: بالنسبة للتبريد هل ترى التكييف لدينا الآن مناسب أم مضر؟ في السابق كنا نهدف إلى المحافظة على درجة الحرارة والرطوبة والنقاء المناسب، أما الآن فنعطي أنفسنا هواء معاد تدويره يرفع الميكروبات معه ويعيدها إلينا، ويزيل الرطوبة من الهواء ويعيده ليدخل جاف إلى العظام، نحن نبتدي بالإشكالات نضعها نصب أعيننا، ثم نوجهها للمكان والظرف المناسب.
وفي إجابته على سؤال بشأن الاستدامة بين العولمة والمحلية، قال: يفترض يكون لدينا تقييم ذاتي، نحتاج تنمية ذاتية من عندنا وليس بالاستيراد من الآخر، وإلا فلدينا قيم موجودة أصلا بتراثنا كما في ”لا ضرر ولا ضرار“، ”ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس“، النسيج العمراني وتأثيره على السلوكيات يحتاج محاضرة أخرى، لدينا ممارسات فردية أو مجتمعية بعيدة عن قيمنا، لضعف التواصل مع تراثنا في القيم كصلة الرحم، فالقيم والمفاهيم هي العلاج لكثير من الأشياء.
وفيما يتعلق باشتراط التشجير حول المنازل بعد ثبوت تخفيض الحرارة بنسبة 30%، وترطيبها الجو، أكد تشجيعه ذلك، داعيًا للوصول إلى نمط مختلف عما نقوم به الآن من استيراد واستنساخ ما يردنا من الخارج، ولا يناسب عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا.