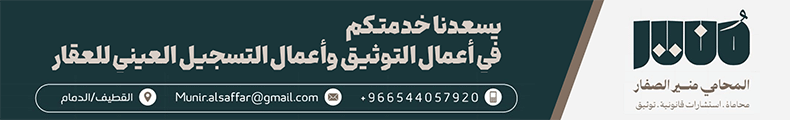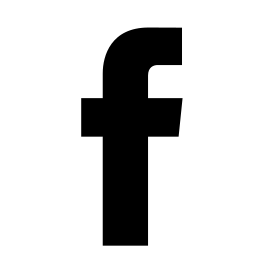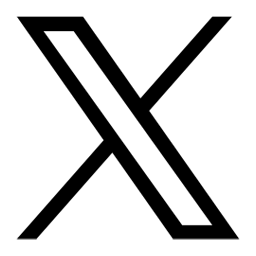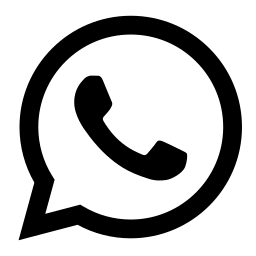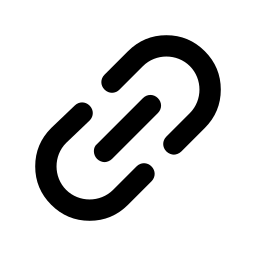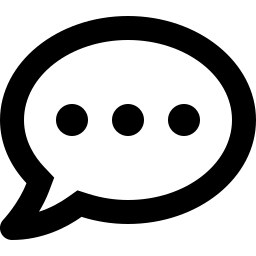من أنا، رحلة في ازدواجية الذات، وتناقض المعايير
أتساءل أحيانًا: من أنا حقًا؟ أهل أعرف نفسي جيدًا؟ ماذا أريد من هذه الدنيا؟ وماذا يريد أخي الإنسان منها؟ يتسابق الطلاب على الدرجات كأن فقدان واحدة منها يُعد كارثة، لا تقل وطأتها عن فقدان والدٍ أو والدة! ويهاجم الأب أو الأم المدرسة بكل ما أوتوا من قوة من أجل علامة ضاعت في الرياضيات أو العلوم. لكن، تُرى: هل سيتألمان بالقدر نفسه لو فقد ابنهما درجة من درجات الأخلاق؟ أو رتبة من رُتب الأدب؟ وأنا، يا من أتكلم الآن بهذا الصوت المرتفع. إلى أي مدى تؤلمني الزلة؟ ويؤرقني الخطأ حينما ارتكبه في حق الآخرين؟ ثمة أسئلة كثيرة لا أجد لها جوابًا، إلا شيئًا يشبه الازدواجية أحيانًا…فنحن - معشر البشر - نلصق أعمالنا بالمبادئ متى ما وافقتها، ونلعن تلك المبادئ ونسفّهها حين تعاكس أهواءنا أو تعجز إرادتنا عن امتثالها.
إن هذا الاختلال في أولوياتنا لا يقف عند التعليم فقط، بل ينسحب على كل حياتنا، حتى في نظرتنا لأنفسنا وواقعنا. في تصوّري، لو أن هلع الأسر وخوفها على أبنائها من فقدان درجة دراسية، هو ذات الهلع من فقدان درجة من كمالات الإنسان - من صدق أو أمانة أو حياء - لرأينا مجتمعًا يعانق السماء في الفضل والخلق. ولو كان هلعي من نقد ناقدٍ شرسٍ لمقالي، هو ذاته هلعي من تأخير فرض أو تفويت عمل خير، لربما كنت أقرب إلى الصديقين والشهداء، وحَسُنَ أولئك رفيقًا. أصرخ بصوت مرتفع: يا ليتني كنت معهم فأُنصرَ الحقَّ فأفوزَ فوزًا عظيمًا! لكن، في الواقع… لا تمتد يدي بماءٍ لعامل نظافة يلهث في قيظ النهار لأنصره على ظمئه، ولا حتى ببسمة لوجه موظف قدّم ربيع عمره تحت إدارتي. بل على العكس: تُسمّى الفظاظة قوة شخصية، ويُسمّى التهكّم على الناس كوميديا، ويُسمّى ظلم الموظفين حنكة إدارية، وتُسمّى الرعونة في قيادة السيارة ”فهلَوة وفنًّا“. لقد انقلبت المعايير، حتى صار التأخّر في نظر الكثيرين تقدُّمًا ورقيًّا.
أظنّنا تائهون. نبحث عن كمالاتٍ زائفة، وأوهامٍ زائلة. ندخل مغارة الحياة، فنجد فيها دررًا ثمينة، وأعشابًا لا قدر لها، لكننا - بغرابة شديدة - نقدّم تلك الأعشاب على الجواهر. وحين تنقلب المعايير، يصبح الإنسان كائنًا غريبًا؛ يبحث عن السعادة حيث يقيم الشقاء، ويفتّش عن اللذة في مواقع البؤس. ثم لا يزال يردّد: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظيمًا ولبيك لبيك، لكن إمامنا  ، حين رأى زيف الدنيا وتحوّلاتها روي عنه قوله:
، حين رأى زيف الدنيا وتحوّلاتها روي عنه قوله:
”إن هذه الدنيا قد تغيرت وتنكرت، وأدبر معروفها، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يُعمل به، وأن الباطل لا يُتناهى عنه؟! ليرغب المؤمن في لقاء الله محقًا، فإني لا أرى الموت إلا حياة، ولا الحياة مع الظالمين إلا بَرَما. إن الناس عبيد الدنيا، والدين لعقٌ على ألسنتهم، يحوطونه ما درّت معائشهم، فإذا مُحّصوا بالبلاء قلّ الديّانون.“
فالمشكلة ليست في قلة المواعظ، بل في عمى البصائر حين تتقاطع المبادئ مع المصالح.