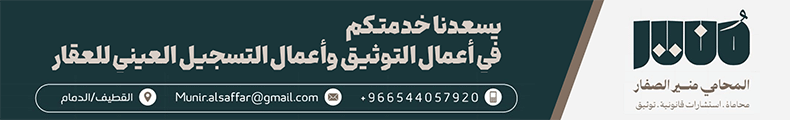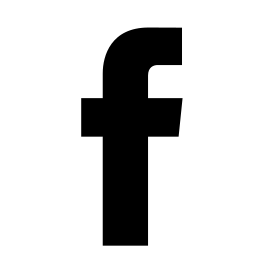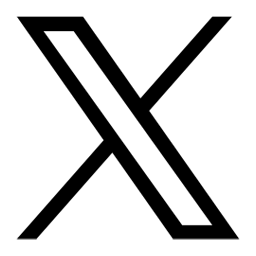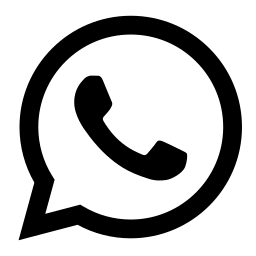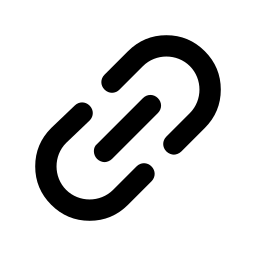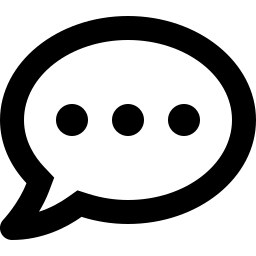من محراب كربلاء إلى منابر اليوم
﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ .. [العنكبوت: 45]
هي آية مرّت عليّ كثيرًا، كأغلبنا. نحفظها، نسمعها، وربما نردّدها دون أن نغوص في أعماقها. لكنني، في الليلة السابعة من محرم، وبين سكون المجلس الحسيني، سمعتها بشكل مختلف تمامًا.
كان سماحة الشيخ فوزي آل سيف يتحدث عن الصلاة. لا كواجب فقهي، ولا كفصل من كتاب الفقه، بل كنبض حياة. وكأن كل ما عرفته عن الصلاة من قبل، كان مجرّد مقدمة.
توقفت طويلًا عند تفسيره للفحشاء والمنكر. قال إن الفحشاء هي ما يخدش طهارة الروح، وما يرتبط بالشهوات والانحرافات الأخلاقية. أما المنكر، فهو ما ترفضه الفطرة، ويستنكره العقل، ويُدينُه الدين. وبين هذين، تقف الصلاة، لا كتحصين خارجي، بل كدرع داخلي. كشيء يُبنى فينا بهدوء، ليُصبح حاجزًا بيننا وبين السقوط.
في لحظة من الحديث، طرح الشيخ سؤالًا لطالما سمعناه: ”فلان يصلي، لكنه يرتكب المعاصي.. فما فائدة صلاته؟“ ولم تكن إجابته دفاعًا عن أحد، بل دفاعًا عن جوهر الصلاة نفسه. قال إن هذه الفريضة ليست معادلة سحرية تجعل الإنسان معصومًا من الخطأ، بل هي طريق مستمر، ومشروع إصلاح لا يتوقف. الذي يصلي، قد يزل، لكنه يظل على الطريق. أما الذي يهجر الصلاة، فهو ضيّع الاتجاه كله.
لم تكن المحاضرة درسًا في الفقه، بل كانت نافذة، فتحت لي بابًا كنت غافلًا عنه. خاصة حين تحدّث عن الصلاة بوصفها فريضة سابقة للإسلام، موجودة في رسالات السماء كلها. وأن لحظة الأذان، لم تكن من وحي بشر، بل من نداء السماء. لحظة المعراج، حيث وقف رسول الله إمامًا للأنبياء، كانت صلاة. لم تكن محاضرة، ولا خطبة، بل صلاة. في ذلك المجلس، شعرت أنني أرى الصلاة لأول مرة.
ثم جاء الجزء الذي مسّ قلبي فعلاً. حين وجّه الشيخ رسالة للآباء والأمهات. أن لا نجعل من الصلاة عبئًا في بيوت أولادنا، بل حبًا. أن لا نصرخ عليهم ”صلّ“، بينما هم لا يروننا نُصلّي بمحبة. أن نرافقهم إلى الصلاة، لا أن ندفعهم إليها وحدهم. كثير من الأطفال لا يكرهون الصلاة، بل يكرهون الطريقة التي قُدِّمت لهم بها.
وفي ذروة المحاضرة، استحضر سماحته مشهدًا من كربلاء يفيض بالنور والدرس: حين أرسل الإمام الحسين  أخاه أبا الفضل العباس
أخاه أبا الفضل العباس  إلى معسكر الباطل لطلب تأجيل القتال حتى سواد الليل، لأداء الصلاة والتوجه إلى الله. وقد رفض البعض، لكن أحدهم قال ”لو أنكم تقاتلون الكفار لأمهلتموهم، فأنتم تعلمون من تقاتلون.“
إلى معسكر الباطل لطلب تأجيل القتال حتى سواد الليل، لأداء الصلاة والتوجه إلى الله. وقد رفض البعض، لكن أحدهم قال ”لو أنكم تقاتلون الكفار لأمهلتموهم، فأنتم تعلمون من تقاتلون.“
وهنا تتجلى المفارقة المرّة: كان معسكر الطغيان يعلم أن الذي يواجههم هو ابن بنت رسول الله ﷺ، ومع ذلك أصرّوا على سفك دمه، في دلالة صارخة على أن معرفة الحق لا تعني دائمًا اتباعه، إذا تلوّث القلب بالهوى.
محاضرة الليلة السابعة كانت نداءً روحيًا لإعادة الاعتبار للصلاة في ضمير الإنسان وسلوكه اليومي، دعوة للتصالح مع هذه الفريضة العظيمة، لا كواجب روتيني، بل كنافذة نور، وبوصلة إصلاح، وصِلة حقيقية بالله عز وجل.
وربما لا نقدر أن نقف حيث وقف الحسين في كربلاء، ولكن نستطيع أن نقف كل يوم بين يدي الله، كما وقف هو، نصلي، ونستعين، ونسأل، ونثبت على طريق لا يُضلّ سالكه، ما دامت الصلاة نوره ودليله.