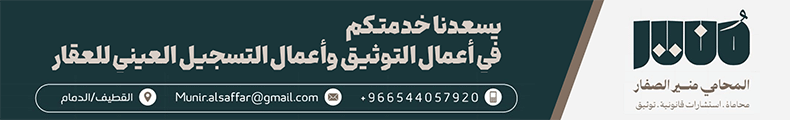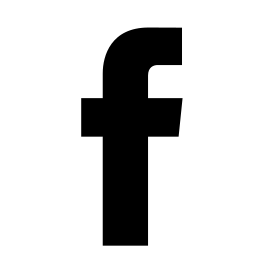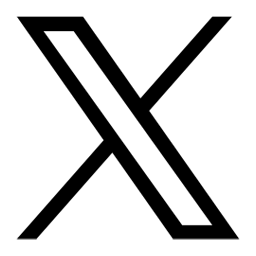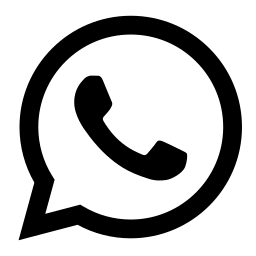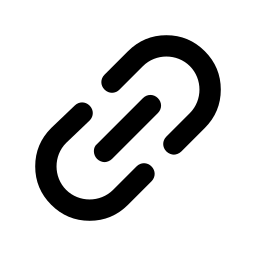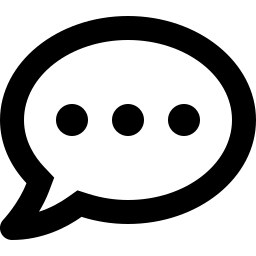الإصلاح يبدأ من الذات وينتهي بالموقف
قال تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم:
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: آية 11] صدق الله العلي العظيم.
إن الذات البشرية ليست مجرد كيانٍ مادي، بل هي عبارة عن نسيج متكامل من المشاعر، والانفعالات، والرغبات والمخاوف، والطموحات، والميول، إضافة إلى القدرات العقلية كالتفكير، والوعي، والإدراك، والقدرة على اتخاذ القرار والتحليل، والقيم الأخلاقية النبيلة كالمبادئ التي يؤمن بها الإنسان مثل الصدق والأمانة والعدل والإخلاص، والقيم الروحية العليا المتمثلة بالإيمان والضمير والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى.
فلا يمكن للمرء أن يغيّر مجتمعة أو يؤثر في محيطه أو حتى في عائلته، دون أن يبدأ بتغيّر نفسه، وفهم أعماق ذاته، والتصالح مع نقاط ضعفه، والاستثمار في نقاط قوّته.
فالإنسان الذي لا يعرف ذاته سيبقى تابعاً للآخرين، مشتتاً، يسير بلا هدف، وبلا غاية، بل ويعيش حياة لا تُمثله.
أما الذي يعيّ ذاته، ويعرف حقيقة نفسه، فسيسير بخطى ثابتة نحو ما يناسبه، ويحقق أهدافه بوعي ورضا بعيداً عن التردد والتقليد الأعمى.
إن معرفة الذات من الداخل تمكن الإنسان من اختيار نمط الحياة الذي يناسبه، وتمنحه القدرة على تجنب المقارنة السلبية مع الآخرين، كما أنها تعزز الرضا عن النفس، وتنمي مهارات التعبير عن المشاعر والتعامل الصحي مع الناس، فالذي يدرك أنه سريع الانفعال مثلاً سيتعلم مع الوقت كيف يهدأ قبل الرد، وكيف يحافظ على علاقاته ويحمي نفسه من التهور.
أما الذي لا يعرف نفسه أو ذاته، فقد يضيع بين مسارات لا تشبهه، فيدرس على سبيل المثال تخصصاً لا يحبه أو يعمل في وظيفة لا تليق به، أو يتبنى أفكاراً ليست نابعة من ذاته، بل قد تكون مفروضة عليه من المجتمع أو من المحيط أو حتى من العائلة.
كما أن الرحلات تبدأ بقرار داخلي كذلك رحلة إصلاح النفس، تبدأ بمواجهة صادقة مع الذات، وفي هذه الرحلة يكتشف الإنسان من يكون؟ وما الذي يريده بالضبط.
صحيح أن هذه الرحلة قد تكون شاقة ومليئة بالتحديات، ولكنها ستفتح له آفاقاً جديدة، وتخلق له تحوّلات داخلية عظيمة، وقد ورد عن الإمام على  أنه قال ”لا خير في العيش إلا لرجلين، رجل ُ يزداد في كل يوم خيرا ورجلُ يتدارك سيئّته بالتوبة، وقد صدق العلي العظيم حينما قال ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: آية 9- 10]“
أنه قال ”لا خير في العيش إلا لرجلين، رجل ُ يزداد في كل يوم خيرا ورجلُ يتدارك سيئّته بالتوبة، وقد صدق العلي العظيم حينما قال ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: آية 9- 10]“

في صحراء كربلاء لم يُحارب الإمام الحسين  لأنه كان مجهولاً أو لأنه لم يكن معروفاً، فنسبه وموقعيته ومرجعيته كانت واضحة للعيان كوضوح الشمس في رابعة النهار، ولكنهم رفضوه، وحاربوه ومن ثم قتلوه لأن نفوسهم الضعيفة لم تكن تحتمله، فهو الإمام المعصوم المفترض الطاعة، وضمير الأمة، ومن يمثل القيم الخالدة بعد رسول الله ﷺ، وأنه لم يخرج حينما قرر الخروج على يزيد لطلب السلطة أو الجاه أو المال أو الشهرة أو... الخ وإنما خرج لإحياء دين جدّه فهو القائل ”إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي“ في المقابل كان يزيد يمثل مصالح الدنيا وهذا الصراع هو لبُ كربلاء.
لأنه كان مجهولاً أو لأنه لم يكن معروفاً، فنسبه وموقعيته ومرجعيته كانت واضحة للعيان كوضوح الشمس في رابعة النهار، ولكنهم رفضوه، وحاربوه ومن ثم قتلوه لأن نفوسهم الضعيفة لم تكن تحتمله، فهو الإمام المعصوم المفترض الطاعة، وضمير الأمة، ومن يمثل القيم الخالدة بعد رسول الله ﷺ، وأنه لم يخرج حينما قرر الخروج على يزيد لطلب السلطة أو الجاه أو المال أو الشهرة أو... الخ وإنما خرج لإحياء دين جدّه فهو القائل ”إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي“ في المقابل كان يزيد يمثل مصالح الدنيا وهذا الصراع هو لبُ كربلاء.
وإنما أطاع الناس يزيد وتركوا الحسين  لأنهم قدّموا مصالحهم الشخصية على القيم الدينية والإنسانية فاختاروا السلامة، والخوف، والمال، والراحة الزائفة على التضحية من أجل الحق، وكما قال أمير المؤمنين
لأنهم قدّموا مصالحهم الشخصية على القيم الدينية والإنسانية فاختاروا السلامة، والخوف، والمال، والراحة الزائفة على التضحية من أجل الحق، وكما قال أمير المؤمنين  ”الناس من خوف الذل في ذل“ فضلاً عن قلة الوعي وضعف الضمير وغياب شجاعة الموقف.
”الناس من خوف الذل في ذل“ فضلاً عن قلة الوعي وضعف الضمير وغياب شجاعة الموقف.
وعند هذه المفارقة يمكنني القول بأن وجود الحق وحده أو القيم وحدها لا يكفي، وإنما لا بد من الوعي والبصيرة والشجاعة في الدفاع عنه بل وتحمل الثمن، ولذلك ورد عنه  في يوم عاشوراء أنه قال ”الناس عبيد الدنيا والدّين لعقُ على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلّ الديّانون“
في يوم عاشوراء أنه قال ”الناس عبيد الدنيا والدّين لعقُ على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلّ الديّانون“
ولذا ينبغي علينا اليوم أن لا نعيش كربلاء كحدث عابر فقط بل علينا أن نعيشها كمرآة لتعكس مواقفنا من الحق فكل لحظة نسكت فيها عن ظلم أو نبرر فيها عن باطل أو نُساوم فيها على قيمة، فنحنُ في الواقع نُعيدُ تمثيل مشهد كربلاء، بل ولا نؤمن بما نقول إن " كل يومٍ عاشوراء، وإن كل أرضٍ هي كربلاء.
علينا أن نتعلّم من كربلاء أن الإنسان لا يُقاس بما يعرفه أو يملكه من مال أو جاه أو شهرة أو درجة علمية أو.. بل بما يُضحي به، وما يحسنه، وأن الحسين  ليس مجرد ذكرى نبكيها أو نلطم عليها وفقط، بل هي مدرسة نسير على نهجها، ونتعلم منها
ليس مجرد ذكرى نبكيها أو نلطم عليها وفقط، بل هي مدرسة نسير على نهجها، ونتعلم منها
وإنا لله وإنا إليه راجعون