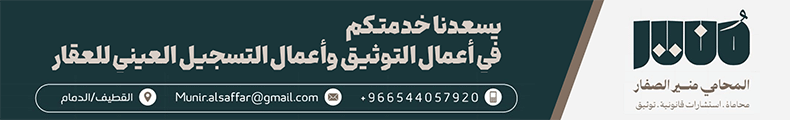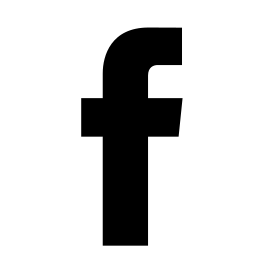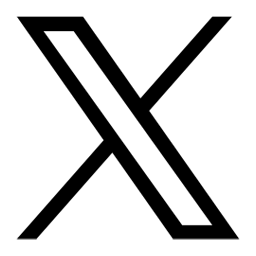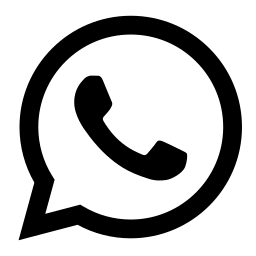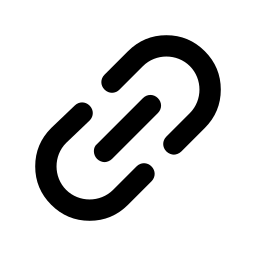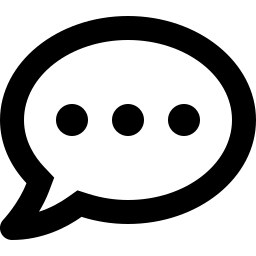اللغة التي تذبح بالورد: حين يتصارع الأدب بين التاج والعكاز
في عالمٍ تنحني فيه الكلمات كل مساء كي تُلصق أذنيها على أبواب الروح، يبقى الأدب ذلك الكائن الهارب من التعريفات، المتمنّع على التصنيفات، لا يُلبَس قميصًا واحدًا، ولا يقبل أن يُساق في قافلة واحدة بين النخبة والعامة. هو كائن غريب… يُشبه شاعرًا ينام تحت جسر لكنه يكتب بنزق الملوك، أو يشبه وزيرًا سابقًا يبيع القهوة في زقاق لكنه يتكلم كأن سقراط أوصاه بالحكمة قبل وفاته بخمس دقائق.
لطالما اختلف العشّاق في الأدب، فمنهم من أراده أن يتدلّى من السقف كنجفة فلسفية، تتطاير من بلورها اقتباسات شائكة وأفكار معقدة لا تُفهم إلا بإذن مسبق من أستاذ جامعي ومترجم لغوي ومُفسر أحلام. وهؤلاء هم النخبة، لا يقرأون إلا ما يعاني من فقر جماهيري، ويشكّون في أي نص تُحبّه أمّهاتنا.
ومنهم من أراده بسيطًا ككلمة ”يا بوي“، قريبًا كملعقة شاي، دافئًا كأغنية شعبية تُبكى وتُغنّى في نفس الوقت. وهؤلاء هم جمهور العاطفة، جمهور ”الخبز والدمعة“، يرغبون في أدب لا يتأنق كثيرًا، بل يربّت على الكتف، ويمسح الغبار عن القلب دون أن يقدّم سيرة ذاتية.
لكن ماذا لو قلنا إن الأدب لا يختار أصدقاءه بهذه الطريقة؟
بل الأدب - الحقيقي - يعبر بين الشريحتين بخفة ساحر، فيكتب للنخبة بلغة يفهمها العامة، ويكتب للعامة بقلبٍ يحترمه الفلاسفة.
الأدب النخبوي، حين يتخلّق من رحم الفكر الخالص، يُشبه النافذة في مكتبة مهجورة، تطل على غابة من الأسئلة. هو أدبٌ لا يُمنح فورًا، بل يُكتشف تدريجيًا، يحتاج إلى قارئ صبور يُزيل غبار اللغة ليصل إلى المعنى.
هو ذلك الصوت الذي لا يُعلَن في الشوارع، بل يُتداول في الهوامش، يحرّك العقول لا الأكتاف، ويطلب من قارئه أن يكون جزءًا من النص، لا مجرّد متفرج.
لكن النخبة ليست دائمًا جميلة. أحيانًا تُصاب بغرور النُّدرة، فتظن أن المعنى لا يكون عظيمًا إلا إذا تعذّر على تسعة أعشار الناس.
فيصير النصّ مثل بابٍ لا يُفتح إلا بكلمة سرّ من العصور الوسطى.
أما الأدب الشعبوي، فهو الولد الذي لا يخجل من الضحك بصوتٍ عالٍ، ولا يطلب إذنًا ليُبكيك من الصفحة الأولى.
هو أدبٌ يلبس جلابية، ويجلس في المقاهي الشعبية، ويتحدث عن الخبز والحب والوجع دون تكلّف.
لا يحتاج إلى ”نظرية التلقي“، بل يحتاج إلى قلب حي.
لكن شعبيته لا تُقلل من عمقه… فالعمق لا يُقاس بعدد الجُمَل المعقدة، بل بعدد القلوب التي استقرت فيها الجملة الأولى.
غير أن هذا الأدب قد يُصاب أحيانًا بسطحية مدروسة، فيظن أن السهولة تعني التفاهة، فيتحوّل إلى مشهد هزلي، لا يترك في النفس إلا فراغًا لذيذًا يزول بعد خمس دقائق.
الحقيقي لا يسكن القصور وحدها، ولا يبيع الفلافل فقط.
هو الذي يجعل النخبة تبكي، والعامة تفكّر.
هو الذي يجمع بين عطر الفكر وحرارة الواقع، بين قصيدة تكتبها بدمعة وقصيدة تكتبها بتجربة.
أنظر حولك…
هل قرأت شيئًا نخبويًا مسَّ أعماقك؟
هل مرّ بك نص شعبي فاجأك ببلاغته الخفية؟
إن كانت الإجابة ”نعم“ … فأنت تعرف أن الأدب لا يُختزل في مكان واحد.
الأدب ليس زجاج نافذة ولا رصيف طريق، بل هو تلك اللحظة التي ترى فيها طفلاً يتأمل القمر ويتساءل: ”لماذا لا يسقط؟“
نخبويًّا كان أو شعبويًّا، لا يهم…
المهم: هل جعل هذا الأدب قلبك يتساءل؟
هل ضرب فيك وترًا قديمًا، نسيت أنه موجود؟
هل أيقظك، حتى لو بلطمة ناعمة أو وردة تذبحك بابتسامتها؟
إذا فعل ذلك، فهو أدبك، ولو لم يُفهمه أحد.
وإن لم يفعل، فلو كتبته الآلهة، لا يساوي نصف تنهيدة.
الأدب لا يُقاس بالمكانة، بل بالأثر.
فدعوا التاج للعقول والعكاز للقلوب، ولنمشِ جميعًا خلف النصّ الذي يقدر أن يقول الحقيقة… دون أن ينسى أن يربّت على أكتافنا.