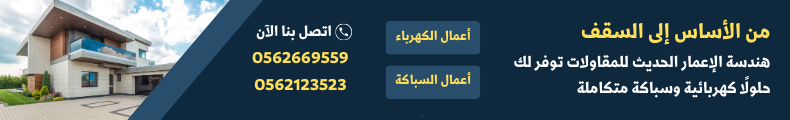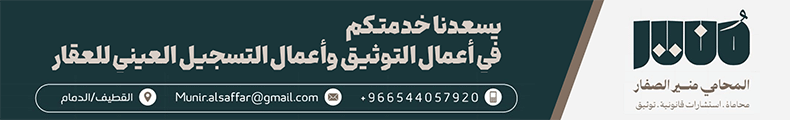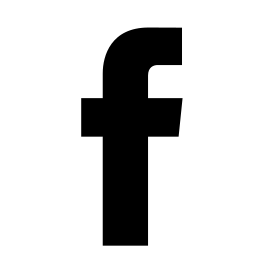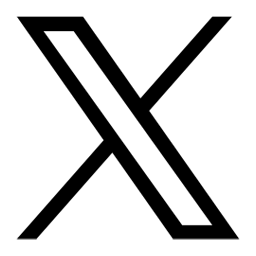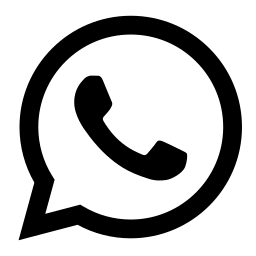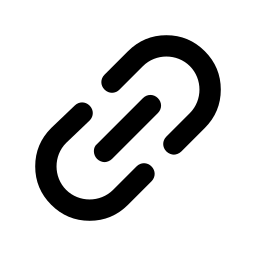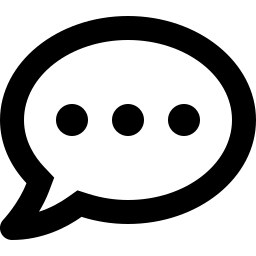الوعي بالكتابة (1): الإنسان، الزمان، الفعل
الإنسان يرتكب الأخطاء مرة بعد مرة، ولا فرق إن كانت بوعي أو بدون وعي، فالمهم حصول الأخطاء وتكرارها، ولهذا يجد الدروس التاريخية شديدة الصعوبة في نفسه حينما يريد استخراج العبر منها، فرغم ما بينه وبينها من فارق زمني ومكاني إلا أنها تستمر بالتمثل في داخله وتستولي على ذهنه؛ حتى تصبح الصورة الثقافية مرسومة بناء على معطياتها، ومفهوم التاريخ هنا لا يتوقف عند الأحداث والشخوص والتغيرات، وإنما يشمل ما وراءها من أحداث وأسرار، وعلى رأسها مسائل الفكر والفلسفة والدين والاجتماع والسياسة والاقتصاد إلخ؛ أي كل ما يمت للثقافة بصلة من قريب أو بعيد.
الإنسان كائن اجتماعي يأنس بمن حوله ويتفاعل معهم ويستفيد من وجودهم لإثراء حياته، وحينما أراد ترسيخ الإثراء اتجه إلى التدوين، حيث الشفاهية تغلب على عصور ما قبل الحضارة، فالبدو الرحل بين الأراضي الشاسعة اهتموا بتوثيق لحظتهم الحاضرة ولم يتجاوزوها، والسبب يعود إلى ظروفهم القاسية، حيث أجبرتهم على البحث عن وسائل للحفاظ على الحياة والاستمرار فيها؛ لهذا اعتبرت الحضارة مظهرا متقدما من مظاهر الوجود؛ لكونها اكتسبت أبعادا لم يستطع البدوي الوصول إليها، وإن احتفظ لنفسه بالتأمل والتفكير وسعة الأفق وامتداد الرؤية، وهو ما جعله أقرب إلى الحكمة من التوحش والبدائية.
الحكمة ميزان يزن به المرء أفعاله وأقواله، ولها حساب دقيق عند من يتخذونها مسلكا حياتيا، والبدوي شاهد على ذلك في وجوده وممارسته، إذ يتخذ مما يحدث حوله أو يتعرض له من المصاعب سبيلا يمده بالمعرفة، وقد يستغرق وقتا طويلا في تأملاته ويسبح بعيدا مع أفكاره وخيالاته، مثلما يشاهد لدى بعض الديانات الأخلاقية، في استعمالها لسلوكيات خاصة كسلوك اليوجا، الذي يعتبر تراثا دينيا وسلوكا حياتيا يصل بالمرء إلى نوع من الهدوء الحكيم، القادر على ضبط الانفعالات والأحاسيس، وكذلك الاقتراب من الطبيعة والامتزاج بها، ولهذا حينما انتقل الإنسان من البداوة والترحال إلى الحضارة والاستقرار احتفظ به.
الاحتفاظ بالسلوكيات الهادفة للوصول بالإنسان إلى الحكمة لا تقتصر على مرحلة البداوة، إذ الحضارة قامت أساسا على هذا النوع من الفعل، وهو إخراج الأفعال والسلوكيات والأقوال غير الحكيمة وإبعادها عن إدارة الحياة؛ كي تغدو أكثر انسجاما مع الأفكار والمعتقدات، وهذا هو الهدف النهائي لأي حكمة إنسانية؛ إذ تتمثل في إحداث الانسجام المطلوب بين الذات والوجود، أما الطريقة التي اعتمدت عليها الحضارة واستعملتها فهي الخط والكتابة، حيث ستكون مرحلة لاحقة من مراحل الوجود الإنساني في صيغته الأكمل والأرقى؛ لأن كل فعل كتابة هو ارتقاء واقتراب من الكمال، وعبره يمكن فهم العبارات التي تعلي من شأنها وتمتدحها وتراها لا غنى عنها في مسيرة الإنسان.
الاتجاه للكتابة والتدوين خلق حالة مختلفة من الوعي الإنساني، فالشفاهية التي امتدت بجذورها عميقا أصابها الكثير من الخلل؛ كالنسيان والإنكار والفقد والتشتت وعدم التذكر والاختلاط، بخلاف الكتابة التي خلت من هذه العيوب وظلت محافظة على مقاصدها وترتيبها؛ لذا استمرت فاعليتها وتأثيرها ولم تقتصر على فرد واحد، بل انتشرت وتوسعت وشملت كل فرد قادر على القراءة وفك الخط، وهنا تكون الحضارة قد وصلت إلى قمتها العالية في التأثير على الوجود الإنساني، حيث الانتقال من طور الحكمة الشفاهية إلى طور الحكمة الكتابية؛ تعني أن يكمل الإنسان ما بدأه السابقون ولا يتوقف عندهم؛ لأن الكتابة تقدم وزيادة على السابق وعدم الاكتفاء بالبقاء عنده، وهذا مشاهد في العلوم والمعارف، وإن كان يتجاوزها إلى الحكمة والتأمل في الحياة؛ كونه يهدف إلى إعطاء الإنسان وعيا أكثر شمولا واتساعا.
الوعي الشمولي والمتسع يمثل لحظة التنوير العليا، فعملية التأمل والتفكير والمراقبة ومعاودة النظر تهدف إلى استخلاص العبر والنتائج؛ أي الوصول إلى الأهداف النهائية من كل هذه العمليات التي يقوم بها، متمثلا في اكتشاف حقيقة الأشياء ثم الحكم عليها، وبهذا يتوحد المفهوم (الحكمة) بالمصداق (الحكيم)، ويصبحان متداخلين متمازجين يدل كل واحد منهما على الآخر، فالحكمة لا ينطق بها إلا إنسان حكيم، والإنسان الحكيم لا ينطق إلا بالحكمة.
الانتقال الكبير والهائل للبشرية حدث مع صعود الكتابة والتدوين، والانطلاق نحو إكمال ما بدأه السابقون عوض التشييد والبناء من جديد، وهذه قمة الحكمة التي يمكن أن يصلها الإنسان؛ لأنه يهدف إلى تجاوز المحيطين بما يحملون من أفكار وسلوكيات وأقوال، وهو ما يمكن مشاهدته لدى العلماء والدارسين، وكذلك لدى الأشخاص الاعتياديين خلال حياتهم اليومية المعتمدة على نقل الخبرة والتجربة، لأن الخبرات البشرية القائمة على التجارب الشخصية تعد مخزونا هائلا من الحكمة، ولا تظهر إلا إذا تمت استثارتها عبر التفاعل مع حدث أو شخص، أما حينما لا يتم استثارتها فإنها تظل في حالة خمول وبعيدة عن الذهن، وهنا يحضر التدوين كأهمية وفاعلية.
يمتلك التدوين ميزة كبيرة في الحياة، فإضافة إلى كونه يحفظ العلوم وينقل الخبرات ويساعد على تذكر الضروريات، يساهم كذلك في اتساع أفق الأشخاص الذين يمارسونه، إذ لا تنمو الأفكار وتتسع وتأخذ مكانتها إلا عبر الكتابة والعرض والمناقشة، التي هي كتابة على الكتابة وإكمال لما بدأه السابقون، وهو ما يعني أن كل كتابة ستمتلك بالضرورة أهميتها في ارتقاء الإنسان وجعل حياته أفضل، وستساعد على أن يكون وعيه أكثر شمولا واتساعا، وهذا شرط الإنسان الحكيم، حينما غادر كهفه وارتحل من بداوته ومر إلى زمن التحضر والاستقرار، حيث الكتابة لا تكون مع الاضطراب والارتحال وإنما تكون مع الاستقرار والبقاء، وهي أخص خصائص الحضارة وسبب وجودها واستمرارها.
اتساع الأفق يقود إلى التأثير في المحيط، وكما كان البدوي حكيما متأملا قادرا على رؤية ما يغيب عن أذهان البشر من التفاصيل الدقيقة، كذلك إنسان التدوين في الحضارة اكتسب الحكمة من خلال اطلاعه على الكتابات والبناء على ما سبق من المعارف والتدرج في ترتيبها، إلى أن وصل مرتبة الحكمة عبر وضع الأمور مواضعها، وبهذا تمكن من امتلاك التأثير المطلوب، ليس على البشر فحسب، وإنما على الطبيعة أيضا، فحيثما امتدت يده ووصل بمعرفته استطاع التغيير والتبديل، وبات قادرا على إحداث الفارق، وهو ما يطرح سؤالا في غاية الأهمية حول الأزمنة البشرية التي حضرت فيها الكتابة والتدوين، وهل يجوز وصفها بأنها أزمنة حكيمة؟
لا توجد أزمنة حكيمة وإنما ثمة أشخاص حكماء، يقودون البشرية ويساهمون في ارتقائها واكتمالها وجعل حياتها أفضل، وهؤلاء لا يختص بهم زمن دون آخر، وإن كان الكثير منهم يظهر في أوقات الحضارة وصعود الإنسان وامتلاكه القدرة على إحداث الفارق، وهو ما يشاهد في بناء الدول وتوسعها وسن القوانين الناظمة لحركتها، إذ يزداد الاهتمام بنقل المعارف والخبرات وتداولها، حتى يبدو وكأن جميع أفرادها امتلكوا الحكمة أو جزءا منها، وهذا أمر يعيدنا إلى تساؤل أساسي: هل الحكمة فعل فردي أم جماعي؟ وهل يمتلكها أفراد محدودون أم تمتلكها الجماهير والجماعات؟
مثلما لا توجد أزمنة حكيمة بكاملها كذلك لا توجد مجتمعات حكيمة بكاملها، فالحكمة فعل فردي يمتلكها الإنسان بعد طول ممارسة وتأمل وتدبر وتفكير، وليس جميع البشر مستعدون لمثل هذا الانشغال، ولكن يمكن القول أيضا أن أزمنة الحضارة لا تخلو من كثير من الحكمة والقادرين عليها، ممن يمتلكون أسبابها ويدركون أهميتها، إنما تنقصهم الإرادة والتوجه والمثابرة والصبر والإصرار، وهذا أبرز عيوب الحضارات وسبب من أسباب ارتهانها للغير.
استمرار الحضارات في صعودها وعدم ارتهانها لأخرى منافسة يتمثل في ممارسة الحكمة بأعلى قدر من الالتزام والإصرار، وعدم وجود أزمنة حكيمة لا ينفي وجود أشخاص حكماء يمارسون المهمة ويحملونها على أكتافهم، فالحضارة لا تبنى على المجموع إنما عبر أفراد مخصصين؛ تمكنوا من إحداث الفارق وتأكيد التميز عن البقية، بعد أن استطاعوا الابتكار والتجديد على مستوى الوجود الإنساني، وهذا ما يقوم به كل فرد امتهن التأمل والتفكير والنظر ومتابعة مجريات الحياة وملاحقة مستجداتها؛ لاكتشاف أسرارها وخباياها وإدراك تفاصيلها ودقائقها، ولأن المهمة لا يقوم بها فرد واحد ستتعدد أشكالها وأنواعها واتجاهاتها وستغدو متنوعة المشارب، وقد تصل حد التصارع والتعارك.
الصراعات الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية والقضائية إلخ مظهر من مظاهر الحكمة، إذ بدونها لا يتمكن الفرد من الوصول إلى الحقائق، التي ستبقى طي الكتمان، طالما لا يمتلكها أو يتحدث عنها أحد، وهنا ستحضر الكتابة كأداة بالغة الأهمية؛ هدفها الكشف عن المجهولات ومعرفة الفروقات بين الديانات والأقوام، وما يتمايز به كل منهم عن الآخر، وإدراك حقيقة كل واحد بمعزل عن البقية، خصوصا في أزمنة التخصصية وتشعب العلوم والمعارف، حيث ما عادت تكفي التأملات أو النظر إلى السماء والنجوم مثلما اعتاد البدوي.
التخلي عن الشفاهية والالتجاء إلى الكتابة حاجة ملحة لحفظ الحضارة والاستمرار فيها، ولهذا ستعد الفعل الحكيم في مختلف الأزمنة، حيث الحضارة التي تفتقد الكتابة والتدوين تمارس فعلا غير حكيم، يفضي بالضرورة إلى ارتهانها وانهيارها، وهذا ما أدركه الإنسان القديم والحديث، الذي وجد في استمرار الكتابة استمرارا للحضارة، والتوقف عنها توقف عن الصعود وبداية الهبوط، وهو ما يعني أن للكتابة كفعل أهمية بالغة في إعادة التوازن للوجود، من حيث التأثير في المستقبل، ورسم مدياته وآفاقه، وكشف حقائق الحياة للأجيال المعاصرة والقادمة، والحفاظ على تراثها ومكتسباتها الماضية.
الكتابة فعل حكيم، مارسه السابقون وأجادوا استثماره في التأليف ونشر المعرفة، أو تدوين القضايا والمسائل المتعلقة بالدولة والتاريخ والأنساب والاختلافات والمناسبات إلخ، مدركين ضرورة احتوائه على بعدين أساسيين لاكتساب القدرة على التأثير؛ هما النظر إلى الماضي والاستفادة من حقائقه والتطلع إلى المستقبل ومحاولة إحداث الفارق، فأي كتابة لا تحمل هذين البعدين ستغدو عاجزة عن تقديم ما يشفع لها بالبقاء والاستمرار، بما فيها الكتابات المتعلقة بالقضايا الهامشية والأحداث الصغرى والأفراد المنبوذين والذين لا قيمة لهم، إذ تتم الاستفادة منها لاحقا في إعادة تشكيل القوانين وسن التشريعات، بما يكفل تنظيم الحياة بشكل مختلف وأكثر انسيابا وسهولة.
أهمية الكتابة لا تقف عند حد، لكن هذه الأهمية ترتبط بمدى انتشارها وشيوعها وتداولها، فكلما كثر القراء ازداد تأثيرها وتعاظم أمرها، وبالعكس كلما قل تداولها واقتصر على عدد محدود تضاءل تأثيرها وغدا لا يذكر، وهنا تحضر وسائل النشر كأداة أساسية في إعانة الكتابة على إكمال دورها وإكسابها سمة الفعل الحكيم بكل تجلياته؛ لأنها إن لم تؤثر ستفقد سمة الحكمة وستغدو من مؤرشفات التاريخ، وهذا ما يجعل الاهتمام منصبا على الوسيلة والحامل إضافة إلى المكتوب والمعنى؛ الأمر الذي يفتح أفقا جديدا للبشرية، يناسب مستجداتها ومتغيراتها.
كثرة الكتابات واحتياجها إلى النشر أدى إلى ظهور أشكال تداولية جديدة وعلى رأسها الصحافة، التي تعنى باليومي والراهن والمؤثر والجديد والغريب، حتى باتت تمتاز عن بعضها بما تقدم من عمق وسعة وشمول، وهي خصائص ثلاث لا توجد إلا في الكتابة القادرة على إحداث التغيير، أما الكتابات المتفاوتة والمتقلبة فتنخفض قيمتها وقد تنعدم بحسب توفر الخصائص ومدى تحققها، وهذا أمر يدفع للنظر والتأمل في المكتوب؛ من أجل اكتشاف إمكانياته، ومدى احتوائه على الخصائص الثلاث، وهل فعلا يستطيع إحداث التأثير والتغيير؟
الشفاهية مرحلة اتسمت بالتأمل والتفكر، بينما الكتابية استثمرت المعطيات الحضارية واتجهت لتدوين أفكارها وحفظها حتى تنجو من التحريف؛ ما أسهم في حفظ المعارف والعلوم والبناء عليها، فانتقل الوجود من حالة الفوضى والتشتت إلى حالة الحكمة والتنظيم، وهي أرقى ما يمكن أن تصل إليه الحياة، فالبداوة والترحال تم استبدالهما بالاستقرار والبناء؛ الأمر الذي حمل معه هموما جديدة وأفكارا مختلفة، وعلى رأسها الابتكار في تداول الكتابة ونشرها، وهنا حضرت الصحف وأخذت تحكم قبضتها على القراء؛ ترسم توجهاتهم وأفكارهم، وتعرفهم في الأثناء على المستقبل كاشفة لهم الحقائق الماضية والصادمة، وكلما اتسمت كتابتها بالعمق والاتساع والشمول حظيت بمصداقية أكبر، وتحولت من فعل اعتيادي إلى فعل حكيم قادر على إحداث التأثير، وهو ما توفره مجلة (أقلام عربية) التي يصادف العدد الحالي ميلادها المئوي، إذ اكتسبت الكثير من التأثير واستطاعت امتلاك القدرة على إحداث الفارق؛ نتيجة الموضوعات والمقاربات التي تطرحها ووسائل النشر والتداول التي تتوزع عبرها، ومن المأمول ازدياد تأثيرها في قادم الأعداد.